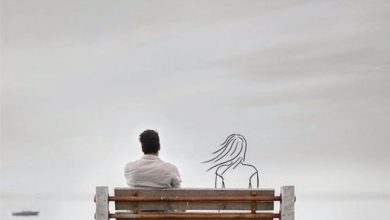عبد الله الحربي.
حين تفتح صفحات عقدة الحدّار *للكاتب والشاعر د .خليف الغالب، الصادرة، فإنك لا تقرأ فصول رواية بقدر ما تُساقُ في رحلة عبر كثبان الذاكرة البدوية، إلى عوالم تتنفس رملًا، .وتتكلم لغة الشداد، وتبكي نوقها حين ترحل.
الرواية، وإن جاءت في 136 صفحة ، إلا أنها تضاهي في مداها وعمقها رَحلًا طويلًا على ظهور الإبل، مفعمًا بالحكاية والعبرة والانكسار.
بدأت الرواية بمقولة للرحالة البولندي “فاتسواف جفوسكي” : “لا يمكن للبدوي أن يكون عبدًا”!، لكنه ما لبث أن راوغ هذا المعنى وأدار عليه الحيلة، إذ جعل بطله مطلق – ابن البادية وصوتها المتوثب – يبيع نفسه في سوق النجف، في مشهد يُصدم قارئه ويستفزه: كيف يرضى البدوي، إرمز الحرية، أن يُعرض للبيع؟
لكن هذا هو مدخل الرواية إلى عقدتها الكبرى :كيف يُحتمل هذا التناقض؟ وكيف نفهم الحرية في وجه الحاجة؟ أهي صفاء الصحراء أم جوعها؟ كرامة النَفَس أم زفرة الأم التي تنتظر مؤونة ابنها؟
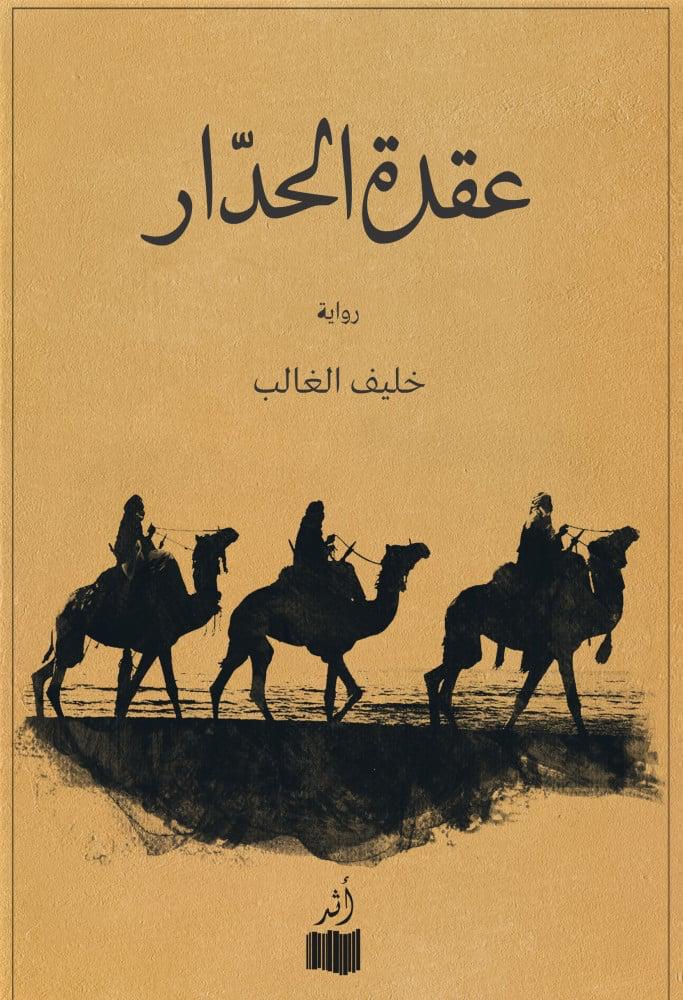
الصحراء : الكائن الحي والمكان الأوحد:
بنية الرواية تتكئ بوضوح على المكان، لا بوصفه إطارًا للأحداث فحسب، بل بوصفه كائنًا روحيًا يتكلم ويفرض منطقه .فالصحراء هنا ليست خلفية، بل شخصية رئيسة، لا تقل أهمية عن مطلق أو أمه، أو حتى قافلة الحدرة التي تمثل خيط السرد الأوضح.
ويبدو جليًا أن الغالب، بوصفه شاعرًا، قد حمَّل الرمل معاني الفناء والبقاء، والضياع والنبوة معًا فمطلق، كما وصف، كان “وجه نبي لم يؤمن به أحد”، وهذا الوصف لا يأتي جزافًا، بل يؤسس لمفهوم الغربة الوجودية، ويقحم القارئ في متاهة البحث عن الذات، والثأر، والحرية المقيِّدة.
قصة مطلق :تمثيل للبطولة الصحراوية في زمن متحرك
مطلق، فتى في الخامسة عشرة، يقف على مفترق الطرق بين الطفولة والرجولة، بين الترحال والاستقرار، بين نداء البادية وحدود المدن .
تركه والده وورّثه شرف الثأر، وأمه تشده إلى رحِم الخوف، لكن القدر يدفعه – أو هو يدفع نفسه – إلى صلب التجربة.
حين قرر أن يرحل مع قافلة الحدرة إلى العراق، كانت رحلته أشبه بمغامرة هوميروسية تنبض بالرمز .فقد ناقته، ثم كاد يفقد كرامته، ليبيع نفسه باسم الكرامة نفسها إو هنا يتجلّى التناقض الفلسفي الذي تَكِنُّه الرواية، في استعارة كبيرة للحرية التي تتكسر حين توضع على ميزان الضرورة.
مطلق يبيع نفسه؟ خيانة للبدوي أم تضحية النبيل؟
تُعد هذه الحادثة – بيع مطلق لنفسه – من أجرأ وأعمق المشاهد في الرواية، وفي الوقت ذاته من أكثرها إثارة للجدل . وفي مفارقة بديعة قال أ. خالد المخضّب: “تذكرنا هذه الحادثة بسيرة أبي زيد الهلالي حين باع نفسه ليطعم قومه. إذ يقول في شعره:
يقول الهلالي والهلالي سلامة
شوف الفجوج الخاليات تروع
يقول الهلالي والهلالي سلامه
يبغي الطمع وهو وراه طموع”. أنتهى.
ولعل الكاتب، في محاكاته لهذا النموذج، أراد أن يُعيد صياغة الأسطورة البدوية ولكن بلغة المعاصرة والرمز، حيث يُصبح “البيع “هنا فعلًا رمزيًا يُدين المدينة التي تشترى فيها الكرامة، لا البادية التي تعتز بالنفس الحرة.
الأسلوب : شاعرٌ يروي نثرًا
يكتب الدكتور خليف الغالب بأسلوب يُشبه القصيدة السردية، تتراقص عباراته على إيقاع الرمل والريح، محمّلة بتأملات فلسفية .ولعل قوله” :حين أراد الإنسان أن يكون عبدًا، اخترع المدينة”، يلخّص روح الرواية في جملة واحدة المدينة هنا ليست جغرافيا، بل قيدٌ رمزي، جدارٌ ضد الفطرة، ونقيضٌ مطلقٌ للصحراء اللامحدودة.
وقال د. برّاك البلوي في مقال عند عقدة الحدار: وفِّق الكاتب في توظيف مفردات الحياة البدوية) :الحدرة، الشداد، الصميل، القهوة (، وأسماء القرى على طرق الحج القديمة كـ”لينة ” و”زبالا”. أنتهى.
أقول: وهذا مما يُضفي على الرواية رائحة الحنين ومذاق التاريخ، فتغدو كأنها مرآة لقوافل غابت، لكنها لا تزال حيّة في القلب.
سارد الرواية :لعبة الالتباس المتعمَّدة
السارد في الرواية شخصية داخلية، عبداللطيف البصري، صديق رحالة إنجليزي يُدعى جاكسيون .وهنا يظهر ذكاء الكاتب في نسج
السرد المتداخل، إذ يتحدث عبداللطيف عن مطلق و عن نفسه، ويخلط بين الشخصي والعام، في كتابة أقرب إلى “الرواية داخل الرواية”، مما يخلق مسافة جمالية بين القارئ والنص، ويمنحه طيفًا من التأويلات.
تشابهات مع أدب إبراهيم الكوني:
من المدهش أن نجد أثرًا قويًا لأدب إبراهيم الكوني في عمل الغالب، إذ يتقاطع معه في الرؤية الفلسفية للبادية، والميل إلى الرمزية والتصوف في تصوير المكان فكما يقول الكوني في روايته “نزيف الحجر – ص 24”: الصحراء كنز، مكافأة لمن أراد النجاة من استعباد العبد وأذى العباد، فيها الهناء، فيها الفناء، فيها المراد»، نجد الغالب يقول :
“…الصحراء هي الامتداد الأمثل لروح الإنسان و الأفق الأرحب لحدوده وسدوده، إنها الهروب الحر من عبث الجدران”.
ورغم ما في رواية عقدة الحدار من شاعرية آسرة وعذوبة لغوية تأسر المتلقي، فقد أشار بعض النقّاد إلى ما رأوه ثغرات منطقية في بعض مجريات الأحداث، كتسارع المصادفات التي تبدو أحيانًا مفتعلة، أو قرار البطل “مطلق ” ببيع نفسه في سوق النجف دون أن تظهر خطة واضحة ومحكمة للنجاة، مما قد يربك القارئ أو يُضعف إيمانه بواقعية السرد. غير أن كل هذه الملاحظات، على وجاهتها النقدية، لا تنفي أن الرواية، وهي باكورة أعمال كاتبها، قد بلغت من الجودة الفنية وجرأة الطرح ما جعلها تترشح لجائزة الشيخ زايد للكتاب – فرع المؤلف الشاب، وهو ما يعد شهادة حيّة على تميز هذا العمل الأول.
بيد أن ما قاله لي الدكتور خليف الغالب ذات مساء، حين سألته عن سر خفيّ من أسرار إحدى رواياته، يُعيد تشكيل هذه النظرة النقدية من جذورها؛ إذ همس لي قائلاً إن عقدة الحدار ليست محض خيال، بل قصة حقيقية وقعت بالفعل لجدّه الخامس، وأن حادثة بيع النفس في سوق النجف قد حدثت فعلاً كما وردت في الرواية. هذا الكشف، الذي يأتي من قلب
التجربة، يهب النص دفقةً من الصدق الفني والعمق الواقعي، ويجعل من تلك المشاهد – التي قد تبدو متطرفة سرديًا – انعكاسًا لحقيقة أغرب من الخيال. إنها ليست حكاية بُنيت في خيال مؤلفها، بل ذاكرة تسربت إلى الورق، فغدت رواية تحيا على الحدّ بين الواقع والأسطورة.
عقدة الحدار “ليست رواية .بل ترحالٌ في السؤال ليست عقدة الحدّار مجرد حكاية عن فتى يبيع نفسه ويبحث عن قاتل أبيه، بل هي محاولة لسبر أغوار البدوي حين يُحاصر بين الضرورة والكرامة، بين السؤال والثأر، بين المدينة والصحراء .هي نشيدٌ طويلٌ، من الرمل إلى الرمل، ومن الإنسان إلى الإنسان.
اقتباسات من الرواية:
– الهمزة مسكينة في كل سطر يتغير وجهها! .
– لا نملك إلا الذكريات يا ولدي، من يموت بلا ذكرى يموت بلا حياة!.
– وديان وشعاب تلك المنطقة آمهات: آم شيح وآم الذيابة وآم طليحة وشعاب آخرى، يجعلون من شعابهم أمهات؛ لأن الأم لا تتغير ولا تُغير! هي هي ، في نظر الصغار الذين يبقون في عينها صغارا.
– لا أحد يتعامل مع الموت على أنه حقيقة ستآتيه، كلنا يرى الموت حقيقة تصيب الآخرين!.
– الغرباء يملكون أحزان أنيقة.
– أنت تكتب لأنك لا تستطيع أن تقتل، تحمل القلم لأنك لا تقوى على حمل السلاح!.
وهذا الاقتباس الأخير قرأتُه في قصيدة للدكتور خليف الغالب بعنوان ” أحاديث الملح “:
صاحَ والصحراءُ تلقى حتفها
لمْ يجدْ في الأرض أرضًا…حين صاحْ
ومضى والموتُ يبري جلدَه
يأخذُ المعنى لغيم الإنزياحْ
بدويٌ…حاملٌ أقلامَه
لم يعد يقوى على حمل السلاحْ!